الحنين إلى الأطلال
ما السبيل إلى عودة السوريين إلى ديارهم؟
أليكس سايمون، وهاجر سرور، وأنس الحناوي
يتوق العالم إلى عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، وكثيرٌ منهم يحلم بذلك، غير أن الحكوماتِ التي يفترض أن تُمهد الطريق أمام السوريين للعودة تضع – من حيث لا تدري – عقباتٍ جديدةً أمام عودتهم، فالدول الغنية لم تقدّم سوى القليل لاستعادة الخدمات الأساسية في سوريا أو إعادة بناء أحيائها المدمّرة، بل تراها تقلص التمويل الإنساني الذي يعتمد عليه أكثر الناس ضعفاً من أجل البقاء، كما أن منظمات الإغاثة التي تعصف بها التخفيضات باتت عاجزةً عن أداء أبسط مسؤولياتها، مثل إبلاغ اللاجئين بظروف الحياة في سوريا، وتتبع أوضاع من عادوا إلى ديارهم. أما الحكومة الانتقالية السورية التي تواجه تحدياتٍ متعددةً بإمكاناتٍ متواضعةٍ فلم تُظهر قدرةً أو رغبةً في تولي دورٍ قياديٍّ في ملف العودة.
إن الأنماط الحالية لا ترضي أحداً، فأعداد العائدين أقل بكثيرٍ مما تتمناه دول اللجوء، وأكبر من قدرة سوريا على استيعابهم حالياً بالنظر إلى اقتصادها المنهار، وبُنيتها التحتية المتداعية. وعلى عكس المعايير الدولية لعودة اللاجئين، ليست كل الرحلات إلى الوطن "آمنةٌ وطوعيةٌ وكريمةٌ"، ولا شك أن بعض السوريين يعودون إلى سوريا لغاياتٍ واضحةٍ، ولتحقيق أهدافٍ شخصيةٍ بعينها، ولا سيما الشباب والميسورون والناشطون في المجال المدني، ومن ليست لديهم التزاماتٌ عائليةٌ، لكن كثيرين غيرهم يعودون تحت الضغط، بعد خسارة وضعهم القانوني أو وظائفهم أو وصولهم إلى المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة؛ ولا يجد معظم هؤلاء بيوتاً يعودون إليها، فيضطرون لاستئجار شققٍ لا يستطيعون تحمل تكلفتها، أو يعيشون في خيامٍ قرب أنقاض منازلهم المهدّمة، فيما أدت موجاتٌ جديدةٌ من العنف وعمليات الإخلاء القسري في بعض أنحاء سوريا إلى تهجير عشرات الآلاف من جديدٍ.
هذه الظروف الصعبة ليست خافية على السوريين الذين لا يزالون في المنفى، ويراقبون وينتظرون ويُمحّصون قرار العودة بدقةٍ، فقد ضحوا كثيراً، وخاطروا بأغلى ما لديهم للوصول إلى بر الأمان في الخارج؛ وأكبر مخاوفهم هو أن يجدوا أنفسهم مُهجَّرين مرةً أخرى وفي حالة ضياعٍ، كما أن بعضهم أسّس في بلد اللجوء حياةً مستقرةً نسبياً، لكن غالباً ما يتوق أكثرهم استقراراً لاستعادة صلتهم بالوطن، وإعادة بناء موطئ قدمٍ هناك على الأقل، وينحدر هؤلاء من جميع المناطق والخلفيات، وتعافي سوريا يحتاجهم جميعاً: رجال أعمالٍ في الشتات يأملون باقتناص فرصةٍ للاستثمار؛ وعمّالٌ فقراءُ يكافحون من أجل النجاة في المغترب؛ ومهنيون وناشطون ومثقفون أعادوا تشكيل حياتهم في المهجر، لكنهم لا يريدون سوى أن يكونوا جزءاً من مستقبل سوريا.
ما الذي يلزم لتمكين السوريين التواقين للعودة إلى ديارهم؟ إن أزمة اللاجئين لا تحل نفسها بنفسها: فكما أن تهجير الملايين تتطلّب أرضيةً صلبةً لاستضافتهم ودمجهم، فإن عودتهم تحتاج إلى ما هو أكثرُ من الخطابات المتفائلة والسياسات غير الناضجة. واليوم يكمن الخطر في خلق حلقةٍ مفرغةٍ، أي خلق وضعٍ يواجه فيه العائدون مشكلاتٍ كثيرةً تَثني الآخرين عن اتخاذ القرار بالعودة.
العودة والندم
كنتُ أظن أن العودة إلى دمشق ستكون أسهل من الحياة في الأردن، لكنها أصعب بكثيرٍ. أبحث عن عملٍ كل يومٍ، فأخرج في الصباح وأعود في المساء. في البداية رحتُ أسأل في محلات الحلاقة ومحال العصائر وحسب، لكني الآن أسأل في كل مكانٍ. أغلب المحلات لا تحتاج أحداً؛ ولذا أستدين اليوم لأعيش، وقد بعتُ هاتفي لأعيل نفسي.
تفكر عائلتي في العودة؛ لكني لا أفتأ أطلب منهم البقاء في الأردن. عادت جدتي، وكم تمنيتُ لو أنها لم تعد لأني صرتُ المسؤولَ عنها، وعليّ أن أجد عملاً لكي أعيلها. إذا لم تكن مستقراً مالياً، فسوريا ستقصم ظهرك. دائماً أقول لأصدقائي: إذا كان بإمكانكم العمل يوماً واحداً في الأردن، فلا تعودوا إلى سوريا، إذ لا رجاء لكم فيها.
خلال الأشهر التي تلت سقوط بشار الأسد، راح السوريون المهجرون يعيدون اكتشاف بلادهم، ولما زال الخوف من الاعتقال أو التجنيد الإلزامي، عاد منهم عددٌ لا يُحصى إلى الوطن لأول مرةٍ منذ سنواتٍ أو عقودٍ، فالتقوا بأحبّتهم وبأقارب وُلدوا في غيابهم، وزاروا القبور، وتفقدوا بيوت عائلاتهم، أو وقفوا على أطلال ما كان يوماً ما منزلاً. اختلطت مشاهد الفرح بلحظاتٍ مؤلمةٍ وصادمةٍ أحياناً لما آلت إليه سوريا: أحياءٌ وقرىً سُويت بالأرض؛ وشوارعُ غارقةٌ في الظلام بلا كهرباء؛ وفجوةٌ كبيرةٌ بين الأسعار التي ارتفعتِ ارتفاعاً جنونياً والرواتب الهزيلة؛ وتعبٌ يرتسم على وجوه من لم يغادروا سوريا يوماً.
ومع تدفق الزوار من كل حدبٍ وصوبٍ، راحتِ المعلومات عن الحياة في سوريا تتدفق إلى الخارج، وكثيرٌ منها اليوم يحمل تحذيراً: "الآن ليس وقت العودة." يردد كثيرون أن سوريا تحتاج إلى وقتٍ: وقتٍ لإنعاش الاقتصاد، وإعادة فرض القانون والنظام، وإعادة بناء المساكن والمدارس والمستشفيات، وغالباً ما تأتي أقوى التحذيرات ممن كانت ظروفهم في المنفى هشةَ لدرجةٍ دفعتهم لاتخاذ قرارٍ متسرعٍ بالعودة النهائية. وفي ذلك قالت أمٌّ لثلاثة أطفالٍ، أخفي زوجها قسرياً على يد نظام الأسد عام 2014: "عدنا من الأردن لنجد منزلنا مُدمَّراً بالكامل." وبعد أن حداها التفاؤلُ بسقوط الأسد، ونظراً لمعاناتها في إطعام أطفالها في الأردن، اختارت تلك السيدة العودة إلى بلدتها المدمرة في ريف دمشق. "انتقلنا إلى منزلٍ يعود لأقاربي، لكنه كان يُؤوي أربع عائلاتٍ مؤلفةٍ من 40 شخصاً يعيشون في ثلاث غرفٍ وحسب. لا أدري كيف عاش الناس هكذا طيلة 14 سنةً، ولا أرى مِن حولي سوى الفقر المدقع، فالناس بلا طعامٍ ولا مالٍ ولا عملٍ، وكلما خرجتُ من ذلك المنزل أجهشُ بالبكاء."
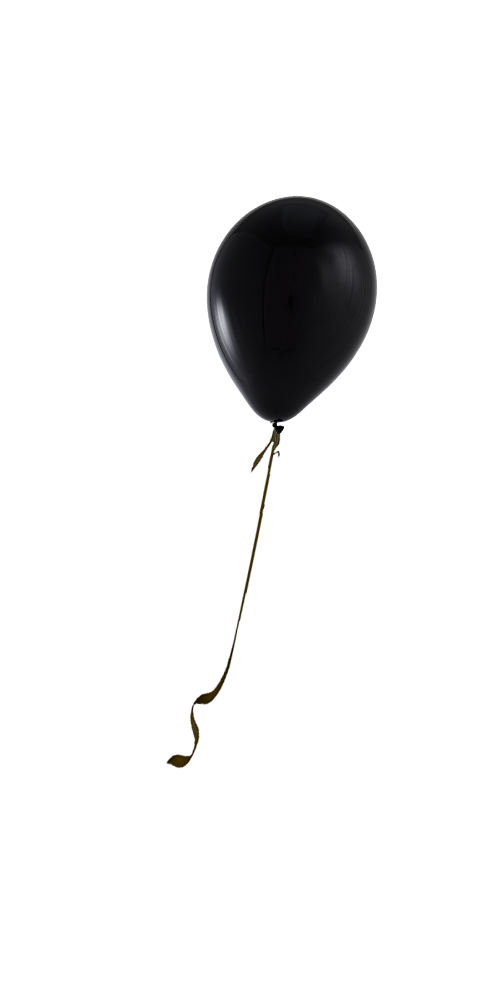
ولا يقتصر الندم على من يعيشون في فقرٍ وفاقةٍ، فهو يراود أيضاً العائدين من أبناء الطبقة الوسطى، كأولئك الذين كانوا يزاولون تجاراتٍ متواضعةً في المنفى، وقرروا المغامرة بإعادة استثمار مدخراتهم في سوريا. قال تاجر ألبسةٍ في حلب: "عاد كثيرٌ من صغار التجار من تركيا فصُدموا بمدى صعوبة النجاة هنا، فهؤلاء أناسٌ برأس مالٍ محدودٍ، وغير معتادين على مزاولة التجارة في هذا البلد، وكثيرٌ منهم نادمٌ على قراره؛ وبعضهم قرر العودة من حيث أتى، فيما لا يملك آخرون خيار المغادرة، ويُجبَرون على إيجاد طرقٍ للتأقلم، أحياناً بتغيير مجال تجارتهم وعملهم بالكامل." وأردف قائلاً إن معاناتهم تشكل رادعاً قوياً أمام رجال الأعمال الآخرين، لا سيما أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة.
ينقسم العائدون النادمون بين من علقوا داخل سوريا ومن يملكون إمكانية الهجرة مرةً أخرى، وتضم الفئة الأخيرة العائدين من لبنان، حيث لا تزال حدوده مع سوريا سهلة العبور. يروي رجل من قريةٍ مدمّرةٍ في ريف حلب محاولته الفاشلة للعودة من لبنان:
عدتُ بعائلتي إلى سوريا بعد سقوط النظام، وقد كنتُ متحمساً جداً للعودة بعد كل تلك السنوات، وخاصةً أننا كنا منهكين في لبنان، لكننا حين وصلنا إلى قريتنا وجدناها مدينة أشباحٍ: لا خدماتٍ، وبيوتٌ مدمّرةٌ، وأسعارٌ مرتفعةٌ جداً. حاولتُ أن أجد عملاً في مهنتي كصانع طوبٍ، لكن البلد يحتاج وقتاً للبدء بإعادة البناء، ولذلك عدنا إلى لبنان عبر طرق التهريب. كان الأمر سهلاً للغاية، كالذهاب من صور في جنوب لبنان إلى بيروت.
وفي عشرات المقابلات مع عائدين ومع من يفكرون بالعودة، كانتِ الأزمة الاقتصادية الخانقة أكثرَ المخاوف شيوعاً، لكنها لم تكنِ الوحيدة، فقد أثارت موجاتٌ من العنف الطائفي الرعبَ بين العلويين والدروز والأقليات الأخرى. ورغم رحيل الأسد شهد السوريون جولاتٍ جديدةً من المشاهد المروعة: نساءٌ وأطفالٌ يُعدَمون، ورجالٌ يُهانون أمام الكاميرا قبل أن يُقتلوا. تختلط الجرائم واسعة النطاق بقصصٍ فرديةٍ لا تُحصى: الخطف مقابل فديةٍ، والاعتقالات التعسفية، وتصفية الحسابات المحلية. أما السوريون ذوو التوجهات العلمانية في الخارج، فيتوجسون من "الجذور الجهادية" للقيادة الجديدة، ويخشون أن تقود البلادَ نحو حُكمٍ دينيٍّ قمعيٍّ. أشارتْ باحثةٌ سوريةٌ في برلين كيف راح هذا المزيج من المخاوف يتغلغل في مجتمعها: "يقول كثيرٌ ممن أعرفهم ممن زاروا سوريا من ألمانيا إنهم لن يعيشوا هنالك أبداً، فاقتصادياً لا يوجد شيء يمكن فعله، ولا عمل، لكن بعضهمُ الآخرَ يشعر بعدم الأمان أيضاً، ويقولون إنهم لا يستطيعون أبداً أن يربّوا بناتهم في بلدٍ كهذا."
ولا شك أن ثمة من كانتِ العودةُ إلى سوريا القرارَ الصحيحَ بالنسبة لهم، فقدِ امتلك بعضهم الوسائل لبدء حياةٍ مستقرةٍ نسبياً: منزلٌ عائليٌّ سلمَ من الدمار، أو قَدرٌ من المدّخرات، أو عملٌ عن بُعدٍ يتقاضون أجره بالعملة الصعبة، والأثمن من ذلك كله جنسيةٌ ثانيةٌ تمنحهم خيار المغادرة في حال تدهورتِ الظروف مجدداً، فيما عانى آخرون أوضاعاً بائسةً في المنفى حدّ أن تَوفُّر الحدّ الأدنى من الموارد في سوريا يُعدّ تحسُّناً ملموساً، لكن قصص النجاح تلك لا تصل إلى العتبة الحرجة القادرة على تغيير المعادلة.

وفي الواقع غالباً ما يروي أوفرُ العائدين حظاً قصصاً عن المعاناة الشديدة؛ قصصاً قادرةً على ثني الآخرين عن العودة بدل تشجيعهم، وفي ذلك قالت شابةٌ تعيش مع زوجها في حيٍّ متضررٍ بشدةٍ في مدينة حمص: "كلفتنا العودة من الأردن كثيراً، إذ دفعنا 350 ديناراً (490 دولاراً) لنقل الأثاث، و100 دينارٍ أخرى للجمارك. في حيّنا بقالةٌ كبيرةٌ وصيدليةٌ، لكن كل شيءٍ آخر بعيدٌ عنا، بما في ذلك الرعاية الصحية. لا توجد مواصلاتٌ عامةٌ، والمدارس غير صالحةٍ للتعلّم." وهي ليست نادمةً على قرارها، غير أن العقباتِ التي تواجهها كفيلةٌ بثني الكثيرين عن العودة، إذ لا يطيق أفقر السوريين دفع تكاليف نقل الأثاث كما فعلتْ، وأما الأيسرُ حالاً فسيترددون في استئجار منزلٍ في حي مدمّر يفتقر للخدمات الأساسية، وهو غالباً الخيار الوحيد المتاح في ظل ارتفاع الإيجارات في المناطق الأكثر صلاحاً للعيش. إن فهم هذه الاعتبارات أساسيٌّ لدعم من يرغب جدياً في العودة.
مواجهة الاحتمالات المستحيلة
في عام 2012 قُتل زوجي واثنا عشر من أقاربي في مجزرةٍ في حمص، فلجأتُ إلى الأردن، وتجنّبتُ لعدة سنواتٍ قراءة الأخبار الواردة من سوريا. لم أرد تذكر ما حدث لنا، لكني رحتُ بعد سقوط نظام الأسد أتابع على فيسبوك مجموعةً تضم نساءً يناقشن الأوضاع في سوريا. كثيرٌ ممن عُدن إلى هناك نادماتٌ الآن بسبب ارتفاع الأسعار، وانقطاع الماء والكهرباء، وقصص الخطف.
غير أني اليوم أشعر بضغطٍ يدفعني للعودة، فقد قلّصتِ الأمم المتحدة المساعدة التي كانت تُبقينا على قيد الحياة في الأردن، لكن أين بوسعي أخذ أطفالي؟ المكان الوحيد الذي يمكننا الذهاب إليه هو منزل أهلي في حمص، لكن كل من كان في ذلك البيت قُتل، ولذا لا أستطيع حتى تخيّل زيارته، فكيف بالعيش فيه؟ لكن البقاء هنا يزداد صعوبة يوماً بعد يومٍ. أشعر بالضياع.
بالنسبة للسوريين الذين يفكرون بالعودة، تختلط التحذيرات القادمة من داخل البلاد بحساباتٍ معقدةٍ ومتغيّرةٍ باستمرارٍ، إذ تتباين تحليلاتهمُ العميقة والمستبصرة بشدةٍ مع المعادلة البسيطة التي ينتهجها واضعو السياسات في العواصم الأجنبية: انتهتِ الحرب، ورحل الأسد، والسوريون قادرون على العودة وسيرغبون فيها. وفيما يكتفي الساسة بإطلاق التصريحات، يغرق السوريون في التفكر والاستشراف، ويجمعون بين عواملَ عمليةٍ كالإيجارات وأسعار الغذاء، وأجور العمل اليومي، والوصول إلى المساعدات والخدمات الأساسية، فضلاً عن عوامل أكثر غموضاً: كيف تفاضل بين خوفك من تعرض أطفالك للمضايقة أو حتى الخطف، وبين تصاعد كراهية الأجانب في المنفى؟ ولذا ينطوي اتخاذ القرار على مخاطرةٍ كبيرةٍ للغاية: فهو قرارٌ يغير حياة أي شخصٍ، وقد يعني الحياة أو الموت للبعض الآخر.
الساسىة يتظاهرون والسوريون يمحّصون
ولذا يحاول العائدون المحتملون جمع المعلومات من أي مصدرٍ يجدونه، ويمشّطون وسائل التواصل الاجتماعي، ويسألون الأصدقاء والأقارب الذين زاروا سوريا أو عادوا إليها نهائياً؛ وعندما تسمح إمكاناتهم المالية واللوجستية، يذهبون لاستطلاع الأوضاع بأنفسهم. يلخّص عاملٌ سوريٌّ في بيروتَ تقييمَه بعد أول زيارةٍ له إلى بلده بقوله: "لا يمكنك أن تعيش كعاملٍ في سوريا لأن الأجور منخفضةٌ جداً، والأسعار باهظةٌ. من يحاول يفشل ويعود أدراجه إلى لبنان، ومن ينجح هم أصحاب رؤوس الأموال القادرون على فتح مشروعٍ ما. أحتاج إلى نحو 25 ألف دولارٍ لأفتح مغسلة سياراتٍ على أرضٍ مستأجرةٍ، و50 ألفاً إذا ما أردتُ شراء الأرض." تفوق هذه المبالغ قدرته حالياً، ولذا اختار الانتظار.
ينبغي على السوريين من جميع الفئات إجراءُ تقييماتهم، ونادراً ما يسهل عليهم اتخاذ القرار: قد يكون منزل الأهل السليم في حيٍّ آمنٍ أفضلَ بكثيرٍ من دفع الإيجار في بلد اللجوء. وبالمقابل؛ إذا كان منزلك مدمراً وتفتقر لأية مدخراتٍ أو دعمٍ للبدء من جديدٍ، فقد يكون البقاء في المنفى الخيارَ المنطقي مهما كانت ظروفك قاسيةً. شرحتْ أمٌّ لخمسة أطفالٍ قرارها بالبقاء في الأردن رغم المشقة بدل المخاطرة بالعودة:

حياتنا في الأردن صعبةٌ، لكنها أفضل من العودة إلى منزلنا المدمّر في ريف حلب، فالناس في قريتنا يعيشون في الخيام. عاد بعض أقاربي، لكنهم ندموا على ذلك، هنا نعيش يوماً بيومٍ، لكننا على الأقل في مأمنٍ.
يعاني زوجي من مشكلةٍ في القلب، وسرطانٍ في الدماغ، ولذا لا يستطيع العمل. تعتمد العائلة على عملي أنا وأولادي. ابنتاي الصغيرتان ما زالتا في المدرسة. أما الأولاد — البالغة أعمارهم 11 و12 و14 عاماً — فيعملون في الشارع، ويبيعون الماء أو يساعدون الزبائن في حمل المشتريات من السوق. مفيدٌ ما يجنونه أياً كان، وعادةً ما يبلغ نحو ثلاثة دنانير (أربعة دولارات) لكل واحدٍ منهم يومياً. تعتقلهم الشرطة أحياناً بتهمة التسوّل، وقد يقبعون في السجن لأسبوعين أو حتى شهر.
إن كثيراً من الحالات أقل وضوحاً من ذلك، ففي سوريا وخارجها من الصعب التنبؤ بالمستقبل بسبب الظروف الاقتصادية المتغيرة. ومع عودة النازحين إلى مناطقهم الأصلية، ارتفعت أسعار الإيجارات ارتفاعاً كبيراً، إلى حد أن التقييم الذي يُجرى في شهرٍ ما لن يتناسب تماماً مع الشهر التالي. يواجه اللاجئون في لبنان والأردن تخفيضاتٍ كبيرةً وغيرَ متوقعةٍ في المساعدات الإنسانية، إلى جانب عقباتٍ متزايدةٍ أمام العمل القانوني. الميزانيات المنزلية التي كانت بالكاد مستقرةً لعدة سنواتٍ باتت مهددةً بالانهيار، سواءً بقي السوريون في المنفى أم عادوا إلى وطنهم.
ولا يقتصر القرار على تأمين الطعام والمأوى يوماً بيومٍ، بل يتعلق أيضاً ببناء مستقبلٍ بعد سنواتٍ من الضياع، وذلك يتطلب أكثر من الطوب والإسمنت. ينظر الأهل بقلقٍ إلى بلدٍ تضررتْ أو دُمّرتْ فيه آلافُ المدارس؛ أما المدارس التي سلمتْ فتفتقر لأدنى معايير الجودة. قال أبٌ سوريٌّ في لبنان بعد زيارة جامعته خلال رحلةٍ إلى سوريا حديثاً: لن أرسل بناتي إلى الجامعة في سوريا أبداً لأني صُدمت من مستوى التدهور: أكوامٌ من السجلات الورقية البالية، ومبانٍ متداعيةٌ، وموظفون غير مؤهلين."
وتحت ضغط عواملَ متناقضةٍ، يلجأ كثيرون إلى حلولٍ مؤقتةٍ بدلاً من اتخاذ قرارٍ نهائيٍّ بالبقاء أو العودة، فتتفرق الأسر مؤقتاً لتقليل النفقات وزيادة الدخل. وقد يستمر الأب في العمل في المغترب، فيما تعود الزوجة والأطفال للعيش مع أهلها في سوريا، أو قد تبقى الأم والأطفال خارج سوريا لإكمال تعليمهم في مدرسة يحبونها، فيما يعود الأب لدراسة إمكانية لمّ شمل الأسرة لاحقاً. قال رجلٌ من حمص يعيش في إسطنبول أنه سيبقى مع عائلته في سوريا ويبحث عن منزلٍ مناسبٍ ريثما تُكمل زوجته الحامل درجة الماجستير في تركيا. لكن معظم أصدقائه يفعلون العكس: "تعود زوجاتهم إلى سوريا ليعشن مع أهلهن، فيما يترك الرجال شققهم المستأجرة في تركيا وينتقلون إلى سكنٍ مشتركٍ بهدف ادخار المال ثم العودة إلى سوريا لاحقاً بمواردَ تكفي لبدء حياةٍ جديدةٍ."
إن من كان جل همه النجاة ليس بوسعه التخطيط للمستقبل
لا يستطيع كثيرٌ من السوريين الآخرين الادخار مهما عملوا أو ضحَّوا. وبالنسبة لمن يؤرقهم صراع البقاء اليومي، لا يعدّ المستقبل شيئاً يمكن التخطيط له بتروٍّ، بل شيئاً ينتظرون ما يحمله لهم. قد تتحسن الظروف في سوريا فيصبح خيار العودة أقل خطراً، أو قد يزداد الوضع سوءاً في المغترب إلى درجةٍ تدفعهم للمجازفة بالعودة، أو سلوكِ طرق التهريب للوصول إلى أوروبا. قال أبٌ سوريٌّ يعيش في بيروت منذ عشر سنواتٍ: "لا أدري ماذا أفعل." يعمل هذا الأب حلاقاً بصورةٍ غير قانونيةٍ لأن مهنته ليست من ضمن المهن القليلة التي يُسمح للسوريين بمزاولتها قانونياً، أما ابنتاه فلا تذهبان إلى المدرسة؛ ولا هو يستطيع دفع رسوم المدارس الخاصة، كما أن المدارس الحكومية صعبة المنال، ورديئة الجودة. ورغم كل الصعاب يأمل أن يُسمح له يوماً ما بالعمل على نحوٍ قانوني في لبنان ليعيل أسرته. "سأنتظر وأرى. قد يتحسن الوضع العامَ القادم سواءً في سوريا أو في لبنان." ما ينقص هذه التقييماتِ الارتجاليةَ هو سياساتٌ أكثر وضوحاً ونفعاً من جانب الدول المضيفة.
عرقلةٌ مدمّرةٌ للذات
اعتقلتني الشرطة التركية في شهر أيلول / سبتمبر بسبب مشكلةٍ في أوراقي الرسمية، وأخذوني مع ثلاثةٍ آخرين إلى مركز احتجازٍ يضم مهاجرين آخرين. سألونا إن كنا نريد البقاء قيد الاحتجاز أمِ العودة إلى سوريا. يتطلب البقاء دفع تكاليف محامٍ، ولذا قلنا إننا نفضل العودة إلى سوريا، فنقلونا إلى الحدود السورية وجعلوا كل واحد منا يقف أمام الكاميرا، وسألونا إن كنا نريد العودة إلى سوريا ضمن برنامجٍ للعودة الطوعية، وكلما رفض أحدنا الإجابة بـنعم، كانوا يعيدون تصوير الفيديو مرةً أخرى.
سأعود إلى تركيا عبر طريق تهريبٍ. يكلف الأمر نحو 500 دولارٍ، ولكن لا خيار لي سواه: عائلتي مكوّنةٌ من أربعة عشر فرداً، وتعتمد على عملي. كنتُ أتقاضى 900 دولارٍ شهرياً من عملي في مزرعةٍ في تركيا؛ فيما لا يتجاوز مجموع ما يكسبه إخوتي في سوريا مئة دولارٍ.
ثمة طرقٌ بدهيةٌ لمساعدة اللاجئين في العودة، من إنعاش الاقتصاد السوري إلى تقديم دعمٍ منهجيٍّ للمستعدين للعودة. والغريب أن ما من حكومة تفعل أياً من هذه الأشياء، فمعظم الدعم المقدم للاقتصاد السوري شحيحٌ ومفككٌ ومنفصلٌ عن أية رؤيةٍ شاملةٍ. اقتصرت إجراءات الحكومات الغربية في الغالب على رفع العقوبات الاقتصادية، بدلاً من تقديم مواردَ جديدةٍ، وتراها تعوّل على دول أخرى مثل الممالك الخليجية لتقديم تلك الموارد. ساعدت قطر قليلاً في تحسين إنتاج الكهرباء، وتعاونتْ مع السعودية لتسوية ديون سوريا المتواضعة لدى البنك الدولي.
الدعم شحيح وعشوائي ويفتقر لأية رؤية شاملة
وإذا كان ثمة أية "إعادة إعمارٍ" تحدث على الأرض، فهي لا ترقى إلى برنامج التعافي الطَّموح والمنسق الذي يوحي به ذلك المصطلح، وإن ما نراه اليوم محضُ خليطٍ غير متجانسٍ لمبادراتٍ على مستوى الأحياء أو العائلات، مبادراتٍ تمولها وتنفذها المجتمعات السورية نفسُها دون أي دعمٍ يُذكر من أية جهةٍ مؤسسيةٍ: لا من الحكومة السورية المؤقتة المفلسة، ولا من الدول الغنية في الخليج والغرب، والتي ساهم بعضها في تدمير سوريا عبر الغارات الجوية والحروب بالوكالة.
كما أن ما من أحدٍ يحثَّ الخطى في وضع رؤيةٍ ما، وفي ذلك قال عاملٌ مخضرمٌ في ملف الاستجابة السورية في أيلول / سبتمبر 2025: "لا توجد خطة تنميةٍ، ولا خطة استثمارٍ." وعلى النقيض من هذا التقاعس، سارعتِ الدول الغنية لزيادة الضغط السياسي من أجل عودة اللاجئين، ففي غضون 48 ساعةً وحسبُ من سقوط بشار الأسد، جمّدت عدة دولٍ أوروبيةٍ طلباتِ اللجوء المقدمةَ من السوريين. (استأنفتْ بعض الحكومات مؤخراً دراسة طلبات اللجوء، لكنها أعلنت في الوقت نفسه نيتها الترحيل القسري لكل من تُرفض طلباتهم). وأشار أحد المانحين الأوروبيين إلى التناقض الذي تخلقه هذه المقاربة: إذ يتحدث المسؤولون عن خططٍ لإعادة اللاجئين إلى بلدٍ مدمرٍ، فيما بالكاد يفعلون شيئاً لجعله قابلاً للعيش:
لا توجد حالياً سياسةٌ لأي شيءٍ يتعلق بسوريا، وما من خطةٍ، ولا آلية تنسيقٍ فعالةٍ، كما أن صندوق التمويل المتاح لسوريا آخذٌ بالانكماش. تحاول الدول الأوروبية إقناع نفسها بأن كل شيءٍ يسير كما تريد، ويستشهدون برحلة عودةٍ طوعيةٍ ضمت نحو 300 شخصٍ، ويعتبرون ذلك نجاحاً؛ لكن لا أحد تقريباً سيعود طوعاً من أوروبا إلى سوريا في ظل هذه الظروف."
وبصرف النظر عن تقاعسها عن إنعاش الاقتصاد السوري، يمكن للدول على الأقل أن تطوّر نظاماً مناسباً لدعم مَن يختار العودة إلى وطنه، من قبيل تزويدهم بالمعلومات قبل المغادرة، ومالٍ يساعدهم في البدء من جديدٍ، وخدماتِ متابعةٍ مثل المساعدة القانونية عند العودة، وهي ضروريةٌ غالباً لاستعادة الممتلكات، لكن هذا الدعم شبه معدومٍ، وما يوجد منه عشوائيٌّ إلى حدٍّ يجعله عديمَ التأثير تقريباً.

وحالياً يتركز الدعم على منحٍ ماليةٍ تُعطى لمرةٍ واحدةٍ، وعلى توفير وسائل النقل للعائدين، لكن هذه الإجراءاتِ لا تلبي الحاجاتِ الحقيقيةَ سواءً في أوروبا أو على الحدود السورية، فالحكومة النمساوية التي تطالب بصخبٍ بعودةٍ جماعيةٍ للسوريين لا تقدم سوى ألف يورو لكل سوريٍّ يوافق على العودة النهائية، وهو مبلغٌ يبدو كبيراً للاجئين ذوي الدخل المحدود، لكنه جزءٌ ضئيلٌ مما يحتاجونه فعلاً للبدء من الصفر. أما هولندا فتقدم مبلغاً أكبر: 2,800 يورو لكل بالغ و1,650 يورو لكل قاصرٍ، لكنها لم تجذب سوى 720 شخصاً لغاية تشرين الأول / أكتوبر. والحال أسوأ بكثير في لبنان والأردن، إذ يحصل العائدون لغاية تشرين الثاني / نوفمبر على 100 دولارٍ للفرد أو 600 دولارٍ للعائلة كحدٍّ أقصى، وهي مبالغُ هزيلةٌ لا تغري سوى أكثر اللاجئين فقراً، وأقلهم قدرةً على النجاة في سوريا، وأكثرهم اضطراراً للفرار مرةً أخرى.
ويواجه أكثر اللاجئين ضعفاً مشكلةً أخرى: انهيارٌ شبه كاملٍ في التواصل مع الوكالات الإنسانية المكلّفة بمساعدتهم، فحتى قبل التخفيضات الأخيرة في الميزانية، شاع عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) أنها غير متجاوبةٍ؛ ولسنواتٍ عُرف بين السوريين أن فرعها في لبنان يهمل خط الاتصالات الطارئة. والآن بات بعض اللاجئين عاجزين حتى عن الاتصال بالمفوضية لتسجيل أسمائهم في برنامج العودة الطوعية الذي روجت له الوكالة بكثيرٍ من التباهي. كما أن البرنامج نفسه محاطٌ بالغموض، ومحيرٌ حتى لبعض متطوعي المفوضية: تقول متطوعةٌ سوريةٌ في شمال لبنان: "لا نعرف من يحق له الحصول على الدولارات المئة. يتحرك اللاجئون في حقل ألغامٍ يكتنفه الضباب، ضبابٌ تصنعه المفوضية نفسها."
ويزداد ذلك الغموض عندما يصل الناس إلى سوريا، فمن حيث المبدأ يجب على الدول التي تدفع السوريين للعودة إلى بلدٍ مدمرٍ أن تنشئ آليةً وطنيةً لمساعدة العائدين في إعادة بناء حياتهم، لكن لا توجد أية آليةٍ من هذا النوع، ولا أي مؤشرٍ على أن أياً منها قيدُ الإعداد، بل لا يوجد حتى نظامٌ فعالٌ لجمع أبسط البيانات حول أماكن استقرار العائدين والظروف التي يواجهونها؛ ففي تشرين الأول / أكتوبر 2025، أعلنتِ المفوضية أن أكثر من مليون لاجئٍ عادوا إلى سوريا منذ كانون الأول / ديسمبر، أي ضعف تقديرات المنظمة الدولية للهجرة (IOM)، ما يثير الشكوك حول دقة الأرقام لدى الطرفين. قالت عاملة إغاثةٍ مخضرمةٌ إنها لم ترَ أي تقدمٍ نحو تضييق هذه الفجوة الضخمة في أبسط رقمٍ يتعلق بالعودة: "يبدو أن الوكالتين لا ترَيان أية مشكلةٍ في حضور اجتماعات التنسيق نفسها، وعرض مجموعتين مختلفتين تماماً من البيانات، دون تقديم أي تفسيرٍ لذلك التباين."
تهمل الحكومات الخطوات الأساسية التي تمكن اللاجئين من العودة
تتحمّل الدول الغنية والمنظمات الدولية قسطاً كبيراً من المسؤولية عن هذا الجمود، غير أن اللوم يقع أيضاً على دول الجوار، ففي تركيا ولبنان والأردن، والتي تستضيف مجتمعةً نحو سبعةٍ من كل عشرة لاجئين سوريين مسجلين عالمياً، تسعى الحكومات، وعلى نحوٍ بدهيٍّ، إلى تشجيع عودةٍ مستدامةٍ وواسعة النطاق، لكن سياساتِها الحاليةَ تقتصر على الضغط على اللاجئين للعودة قبل أن يصبحوا قادرين على تحمّل تكاليف ذلك، الأمر الذي يجعلهم في الغالب أكثر فقراً وتهميشاً ممّا كانوا عليه. تدفع حكومتا لبنان والأردن السوريين خارج سوق العمل، وتحرمهمُ الخدماتِ الأساسيةَ، فتضاعفانِ الألم الناجم عن خفض التمويل الغربي. وأما في تركيا، فلم تُكثّفِ السلطاتُ الضغوطَ بقدر ما واصلت ممارساتِها الممتدةَ لسنواتٍ، والمتمثلةَ في الترحيل القسري للاجئين المتهمين بارتكاب أصغر المخالفات القانونية أو الإدارية. وتحت هذه الضغوط ينوّه السوريون في تلك الدول الثلاث بحسرةٍ ألا شيءَ طوعيٌّ في عمليات "العودة الطوعية" التي تتحدث عنها الأمم المتحدة والدول المضيفة.
ولا تقتصر المشكلة على دفع الحكومات المضيفة الناسَ للعودة على عجلٍ؛ بل تتجاوز ذلك إلى إهمال خطواتٍ أساسيةٍ يمكن أن تُمكّن أولئك السوريين المستعدين للعودة. يذكر كثيرٌ من اللاجئين في الأردن أن أحد الأسباب التي تمنعهم من العودة هو مرضٌ مزمنٌ لا يمكنهم علاجه في سوريا. وكان من الممكن حل ذلك بسهولةٍ عبر منح هؤلاء المرضى الحق في العودة إلى الأردن لتلقي العلاج، وثمة آخرون محاصرون في الأردن بسبب ديونٍ لن يتمكنوا من سدادها أبداً، لكنهم لن يتمكنوا من عبور الحدود إلى سوريا ما لم يسددوها. وتشمل تلك الديون رسوماً باهظةً فرضتها الدولة الأردنية التي تملك كل الأسباب لإسقاطها. لخصت أمٌّ سوريةٌ تقيم في إربد، وتكسب يومياً ستة دنانيرَ وحسبُ (أقل من تسعة دولارات) من عملٍ غير رسميٍّ في مركز تجميلٍ نسائيٍّ، مأزقَها العبثي قائلةَ:
لقدِ اقترضتُ 600 دينارٍ [من برنامج تمويلٍ صغيرٍ] لمساعدة ابني في سداد ديونه، وسرعان ما أصبحتُ مدينةً بـ 1,200 دينارٍ [1,700 دولارٍ]. ولم أدرك أن المبلغ سيزداد بهذا الشكل. كان الحصول على القرض سهلاً جداً، لكني خلال العملية وقّعت على أوراقٍ لم أفهمها. أنا أيضاً مدينةٌ لمؤجر بيتي السابق الذي طردني عندما لم أستطع دفع الإيجار. وأدين بـ 781 ديناراً أخرى لوزارة العمل كرسومٍ متراكمةٍ لأني لم ألغِ تصريح العمل. كنتُ قد حصلتُ على تصريح العمل كجزءٍ من تدريبٍ قدمتْه منظمةٌ غير حكوميةٍ على صناعة الشوكولاتة، حيث منحونا التصريح كي نتمكن من الحصول على بدلٍ ماليٍّ للدورة التدريبية، لكنهم لم يعطونا أي بدلٍ.
* * *
كيف يمكن تفسير هذه السياسات التي تقوّض نفسها بنفسها، من دولٍ تواصل علناً الدعوة إلى عودةٍ جماعيةٍ للاجئين؟ قد تكون أبسط إجابةٍ هي أن ما نراه ليس سياساتٍ حقيقيةً على الإطلاق، بل خليط إجراءاتٍ اعتباطيةٍ تستندُ إلى نزعاتٍ شعبويةٍ أكثر من استنادها إلى مصالحَ وطنيةٍ واضحةٍ، أو إلى الحقوق القانونية للاجئين السوريين أنفسهم.
لا ريب أن انتصار السرديات على حساب السياسات لا يقتصر على سوريا وحدها، فعالمياً تزداد سياسات الهجرة انفصالاً عن أي منطقٍ، باستثناء منطق الاستخدام العنصري للاجئين كبشَ فداءٍ؛ ففي العالم الغني يساور النخبَ الحاكمةَ هاجسُ شيخوخة السكان، وانخفاض معدلات الولادة، وتباطؤ الاقتصادات، ثم يلهبون في الوقت نفسه مشاعر الكراهية الشعبية ضد المهاجرين الذين يعتنون بكبار السن، ويرعون الأطفال، ويُبقون قطاعاتٍ كاملةً واقفةً على أقدامها عبر أعمالٍ متدنية الأجور. وإذا كان لدى أوروبا والولايات المتحدة سياسة هجرةٍ اليوم، فهي تتمثل في تفكيك الإطار القانوني الذي أنشأوه بعد الحرب العالمية الثانية بغية تنظيم وحماية حقوق العمال الأجانب وطالبي اللجوء. والسوريون ليسوا وحدهم في مواجهة هذا التحوّل، لكنهم من بين أكثرهم تضرراً منه: ففي عام 2015 تصاعدت موجة كراهية الأجانب في أوروبا بالتزامن مع زيادة أعداد اللاجئين السوريين؛ وبعد عشر سنواتٍ، لا يزال هؤلاء اللاجئون أنفسهم هدفاً مفضّلاً للخطاب العدائي لدى القوميين الأوروبيين.

ومن المهم الإشارة إلى أن استهداف اللاجئين لا يأتي من اليمين المتطرف وحده، فالمواقف التي كانت فيما مضى تُعدّ متطرفةً أصبحتِ اليوم أقرب إلى مواقف الوسط، بالنظر إلى سعي قادة الوسط ويسار الوسط لمجاراة منافسيهم من القوميين. واليوم لا يوجد أي رفضٍ سياسيٍّ حقيقيٍّ لترك أوروبا المهاجرين يغرقون في البحر المتوسط، أو يُعذَّبون في السجون التركية التي بُنيت بأموال دافعي الضرائب الأوروبيين. وبالمثل نادراً ما يكلّف السياسيون الأمريكيون أنفسهم عناء ذكر المهاجرين الذين يموتون عطشاً في صحراء سونوران وهم يحاولون الهرب من حرس الحدود الأمريكي. وبالتالي لا عجب أن يكون العالم مستعداً إلى هذا الحد لدفع السوريين نحو بلدٍ غير قادرٍ أصلاً على استقبالهم.
يفرض هذا الموقف السطحي قصيرُ النظر ثمناً على من يروجون له، ويشمل ذلك السياسيين الغربيين الوسطيين الذين يجعلون من أنفسهم متورطين وعديمي النفع سياسياً من خلال تقليد منافسيهم من اليمين المتطرف؛ كما يشمل ذلك الأمم المتحدة، والدول المانحة لها، والنظام الأوسع للمساعدات الإنسانية والتنموية: ففي مواجهة أزمةٍ وجوديةٍ في التمويل والشرعية، يتبنّى قادة هذا القطاع تجاه سوريا نهجاً يعلم الجميع أنه فاشلٌ.
ويشمل ذلك البقية منا أيضاً على نحوٍ متزايدٍ، فالهجوم العالمي على المهاجرين، السوريين وغيرهم، يسير جنباً إلى جنبٍ مع هجومٍ على أشد الناس ضعفاً داخل مجتمعاتنا نفسها؛ ففي الدول الغربية الغنية، تُخفي العروض الصاخبة من كراهية الأجانب اندفاعاً أكثر هدوءاً لتمزيق شبكات أماننا الاجتماعي، وينطبق الأمر نفسه بالقرب من سوريا: فمن تونس إلى بيروت، ومن عمّان إلى القاهرة، تُستخدم شماعة المهاجرين لصرف الأنظار عن دولٍ تتهاوى، وأنظمةٍ فاسدةٍ، وطبقاتٍ وسطى تتلاشى، وشبابٍ منسيٍّ، وبؤسٍ يتفاقم.
وفيما نطرد المهاجرين خارج حدودنا، فإننا في الواقع نحرم مواطنينا أنفسهم من الأجور الكافية، والمسكن الكريم، والخدمات العامة الموثوقة. تمضي بعض النخب بهذا المنطق إلى ذروة العبثية: فيتخيلون عالماً يَستبدل فيه الأغنياءُ العمالَ بالروبوتات، وينزوون إلى مجمّعاتٍ مُسوَّرةٍ، أو إلى الواقع الافتراضي، أو إلى المريخ. إن هذه الأوهام ليست أكثر واقعيةً من الظن بأن السوريين اليوم سيتدافعون للعودة إلى بلدهمُ المدمَّر، وكلها تطرح السؤال نفسه: كيف بوسعنا إعادة بناء مجتمعاتنا كأماكنَ تُغيث المحتاجين منا، بدلاً من السعي المحموم لإقصائهم؟
17 تشرين الثاني / نوفمبر 2025
أليكس سايمون هو مدير الأبحاث في سينابس. هاجر سرور وأنس الحنّاوي باحثان في سينابس.
المنهجية
يستند هذا المقال إلى ما يقرب من 130 مقابلةً أُجريت بين كانون الأول / ديسمبر 2024 وتشرين الأول / أكتوبر 2025. ويشمل ذلك نحو 50 مقابلةً شخصيةً في الأردن، و40 في سوريا، و20 في لبنان، والباقي في ألمانيا أو (عن بُعد) في تركيا. وتشمل عيّنة المشاركين سوريين عادوا إلى سوريا أو يفكّرون في العودة، ولاجئين عادوا إلى سوريا ثم رجعوا إلى لبنان، وعاملين في مجال المساعدات، ومموّلين غربيين للاستجابة لأزمة اللاجئين.
الصور والرسومات: تمّام عزام، دمشق (2015)